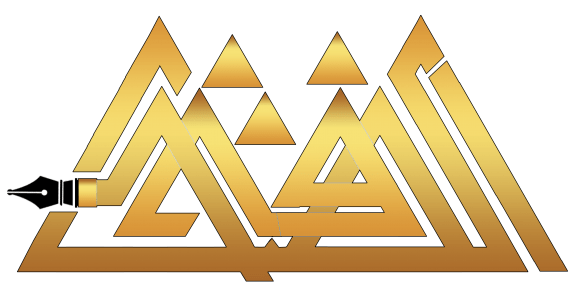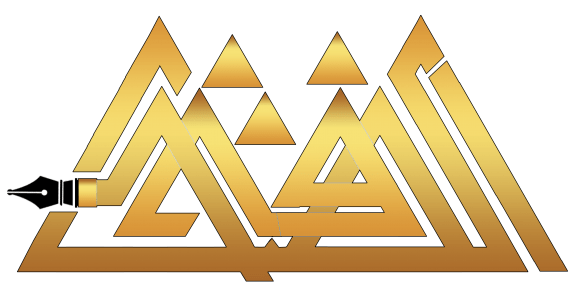(تأملات) ..جمال عنقرة السودان ومصر .. التكامل لم يعد سقفا كافيا

تداولت وسائل الإعلام ووسائطه خبرا من مصر، نصه “أصدر المجلس الأعلي للآثار بجمهورية مصر العربية قرارا بمعاملة المواطنين السودانيين معاملة المصريين بدخول المتاحف والمناطق الأثرية، كما سبق وان أصدرت القيادة السياسة قرارا باعفاء الطلبة السودانيين من 90% من قيمة المصروفات الدراسية في الجامعات المصرية ومعاملة المواطنيين السودانيين معاملة المصريين في العلاج وكافة الخدمات التي يتمتع بها المصريون، وذلك في اطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل وصولا للتكامل بين البلديين الشقيقين، لان مسارنا ومصيرنا واحد في اطار الحرص المصري علي سلام واستقرار الشقيق السودان”
هذا الخبر احتفي به كثيرون من المصريين والسودانيين علي حد سواء، واعتبروه إنجازا عظيما لتعزيز العلاقات الإيجابية بين الشعبين والبلدين الشقيقين، ولا أود أن اقلل من قيمة الخبر، ولا من فرحة المحتفين به، لكنني لم أر فيه ما يحقق طموحي، لا سيما وأني قد عشت وعايشت عهدا زاهرا نضرا بين السودان ومصر علي أيام التكامل في عهد الرئيسين الراحلين، السوداني جعفر محمد نميري، والمصري محمد أنور السادات، وكان عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية قد وصل العشرين ألف طالبا، وكان هذا الرقم يعتبر خرافيا بمعايير ذاك الزمان، حيث كان عدد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات السودانية ومعهد الكليات التكنولوجية عشرة ألف طالب فقط، وكانت جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحدها تضم عشرة ألف طالبا، هم الذين كانت تقوم عليهم الحياة المدنية بصفة أساسية، وكنا في مصر نعامل معاملة الطالب المصري تماما، رسمومنا الدراسية كانت نحو عشرة جنيهات فقط مثلنا مثل الطلاب المصريين، وكان يدفع الطلاب الوافدون من الدول العربية الأخري ومن غيرها أربعة الآف جنيها استرلينيا كل عام، عدا الفلسطينيين الذين كانوا يعاملون مثلنا مثل المصريين تماما، وكان مسموحا للطلاب السودانيين السكن في المدن الجامعية المصرية، وكان الطلاب السودانيون يدفعون للمدينة الجامعية خمسة جنيهات فقط للسكن والاعاشة الكاملة، مثلهم مثل إخوانهم المصريين، وكانت لدينا كروت جمعية لصرف المواد التموينية، وكوبونات لركوب الأتوبيسات، وكان علاجنا في المشافي الحكومية مثل علاج المصريين تماما مجانا، وكنا ندخل كل المواقع السياحية بذات الرسوم التي يدفعها المصريون، وكانت التحويلات المالية تصلنا من السودان عبر كل المصارف، وعبر البريد أيضا، وكان التعامل يتم عبر ما يعرف بالدولار الحسابي، وكان الدولار الحسابي في السودان بخمسين قرشا، وفي مصر بتسعة وستين قرشا، فكانت العشرة جنيهات سودانية تصل مصر ١٣،٨ جنيها، وكان كثيرون من الطلاب السودانيين الذين درسوا في مصر في عهد التكامل – وانا واحد منهم – لم نستخدم جواز سفر قط، فكان سفرنا وعودتنا ببطاقة وادي النيل، وكان طلاب الشمالية يدخلون مصر بالطاقة الشخصية، وكان ذلك متاحا أيضا لمواطني أسوان عندما يزورون السودان، فهل بعد هذا الذي عشناه تكفينا بعض استثناءات مثل التي وردت، رغم تقديرنا لها، فهذا ليس سقف طموحنا، ولا من أجل ذلك نقاتل من أجل أن تصير العلاقات السودانية المصرية إلى ما يجب أن تكون عليه، وهو ما لم تبلغه حتى في عهد التكامل الزاهر، فكل ما كان في ذاك العهد النضير كان مجرد بدايات، وكان الرئيسان الراحلان نميري والسادات يخططان إلى وحدة كاملة، وكان الرئيس السادات ابن خالتنا ام سترين، أو ست البرين كما كان يناديها المصريون، كان قد منح السودان ميناء في الإسكندرية ليطل من خلاله علي البحر الأبيض المتوسط، إلا أن يد المنون أخذته قبل أن يكمل هذا المشروع الحلم في طريق الوحدة الشاملة بين السودان ومصر.
وفي تقديري — وتقدير كثيرين من الوطنيين السودانيين والمصريين- أنه، وفي ظل هذه التحديات التي تجابهنا معا، داخليا، واقليميا، ودوليا لم يعد أمام السودان ومصر سوي الوحدة الشاملة، ولأجل هذا يجب أن نسعي جميعا بدون تردد، وذلك هو السلاح الوحيد الذي يمكن أن نقهر به كل التحديات، ولعلم الذين لا يعلمون فإن الذين يشعلون نيران الفتن بين مصر والسودان هذه الأيام، هم خصوم مصر والسودان، وهم الذين يعلمون أن السودانيين والمصريين لو وضعوا أيديهم فوق بعضهم البعض، وتوحدت صفوفهم، وجمعوا مواردهم البشرية والطبيعية، ومكانتهم التاريخية والجغرافية المميزة، وانطلقوا متوكلين علي الله تعالي، فسوف يكتسحون العالم كله بإذن الله تعالي.
فمرحبا بتلك القرارات المصرية التي أتت في وقتها، ولكنني لم أنظر إليها بأكثر من كونها بشارة خير، وكما يقولون أول الغيث قطرة، وغيثنا ينهمر عندما نلغي كل الحواجز والحدود، ويصير السودان كله، ومصر بلدا واحدا وشعبا واحدا، وليس ذلك علي الله بعزيز.