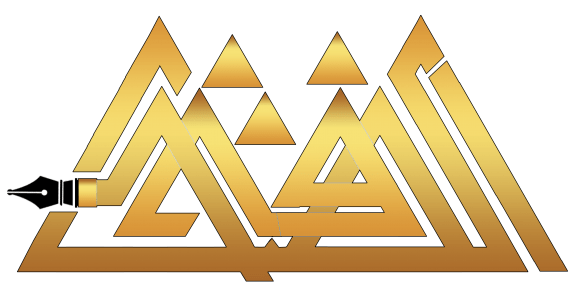خطاب الميرغني رسالة للقوى السياسية (بتوضيحاتها) بقلم : بروفيسور صلاح محمد إبراهيم

توجت الانفصالات بين الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني والدكتور جون قرنق بتوقيع مبادرة السلام السودانية بتاريخ 16 نوفمبر 1988، في اديس أبابا والتي نصت على تهيئة المناخ المناسب لقيام المؤتمر الدستوري ، وأن يتم تجميد مواد الحدود الشرعية وكافة المواد ذات الصلة وقوانين الشريعة الاسلامية ، وـأن لا تصدر اية قوانين ذات الصلة بقوانين الشريعة الاسلامية لحين انعقاد المؤتمر الدستوري ورفع حالة الطوارئ ووقف اطلاق النار غير أن حكومة الصادق المهدي تعاملت مع الاتفاقية بطريقة ممعنة في البيروقراطية والتلكؤ في التنفيذ ، وكان هناك اصرار على ( توضيحاتها) من جانب الصادق المهدي وأهمها أن تتم الموافقة عليها من الجمعية التأسيسية وهو يعلم أن الحزب الاتحادي ليس لديه اغلبية في الجمعية ، وأن الجبهة الاسلامية سوف تعترض عليها، كما أنه لم يكن يريد أن يسجل نصر للاتحاديين بهذه الاتفاقية ، ومع كثرة الخلافات والصراعات حول الاتفاقية وخروج الجبهة الاسلامية من الحكومة ، وتعدد خروج ودخول الحزب الاتحادي من الحكومة ، واستقالة وزير الدفاع الفريق عبد الماجد حامد خليل ومذكرة القوات المسلحة ، ظل الحزب الاتحادي يعتقد أن عدم تمرير الاتفاقية بالسرعة المطلوبة تسبب في انهيار الحكومة وحدوث انقلاب 30 يونيو 1989، وأن تلك (التوضيحات ) حتى بعد إجازة الاتفاقية هي التي خلقت المصاعب أمام استمرار التعاون بين الحزبين ، لذلك لم يكن مصادفة أن يشير مولانا السيد الميرغني في بداية خطابه الأسبوع الماضي إلى الاتفاقية ، بل هو اختار أن يسجل ويعلن خطابه في يوم توقيع الاتفاقية مع قرنق ، وأن يرسل إشارة برفضه لاتفاقية تيسيريه المحامين كمن يقول ( أن بضاعتكم قد ردت إليكم ، كما ردت لنا بضاعتنا في نوفمبر 1988).
يبدو المشهد السياسي اليوم يتمحور حول ثلاثة اتجاهات رئيسية خلال الفترة الانتقالية الأول يرى أن على القوات المسلحة أن تبتعد عن السياسة والسلطة تماماً ، وتيار اخر يرى أن من الضروري مشاركة القوات المسلحة في السلطة ،وأن تكون على رأس السلطة نسبة للظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد ، وفي اعتقادي أن على التيارين أن يتعاملا مع قضية ابتعاد القوات المسلحة عن السلطة بنظرة أكثر عمقاً وموضوعية سواء كان خلال الفترة الانتقالية أو بعد الانتخابات ، واختلف مع ما يتردد حول أن القوات المسلحة قد وافقت على الابتعاد عن السياسة أو السلطة ، فنحن لسنا دولة ذات مفهوم راسخ للديمقراطية والحرية ، مهما يدعي البعض كذباً، وكل تجاربنا الديمقراطية فاشلة مهما اختلفنا حول الأسباب وهل هم العسكريين أو المدنيين ، الممارسة الديمقراطية معظمها شعارات لا ترى النور على ارض الواقع ، ولعل خير مثال وهو له علاقة بقضية الحرية والديمقراطية ، أنه لا توجد حكومة حزبية في السودان منذ الاستقلال وافقت على تجميد قانون الصحافة والمطبوعات الذي ما زال يحتفظ حتى في نسخته الأخيرة أيام الديمقراطية الثالثة عام 1986 وحتى اليوم ، بكل البنود المكبلة للحريات كما وردت في قانون الاستعمار عام 1930.
لقد كان من أسباب فشل حكومة الوحدة الوطنية عام 1989 الموقف المتردي للوضع داخل القوات المسلحة، استقال وزير الدفاع الفريق عبد الماجد حامد خليل من حكومة الصادق المهدي في فبراير 1989، وتقدمت قيادة القوات المسلحة بمذكرة القائد العام فتحي احمد علي إلى رأس الدولة ورئيس الوزراء في 20 فبراير من نفس العام ، والأسباب تعود إلى عجز الحكومة عن توفير احتياجات القوات المسلحة بجانب الخلافات السياسية المتكررة منذ تكوين أول حكومة للصادق المهدي بعد الانتفاضة وانتخابات 1986، أزمات متكررة مثل استقالة محمد الحسن عبدالله يسن من مجلس السيادة ، واعتراض حزب الأمة على استبداله من قبل الاتحاديين بأحمد السيد حمد، وقبل ذلك الخلاف بين السيد مبارك الفاضل المهدي وزير الصناعة وابوحريرة واستقالة الأخير من وزارة التجارة ، بجانب الشروط التي وضعها الصادق المهدي لتمرير اتفاقية الميرغني قرنق وضرورة اعتمادها من الجمعية التأسيسية ، ولم يكن الحزب الاتحادي يملك اغلبية لتمريرها، والضغوط النقابية والدولية ، كل ذلك تسبب في حدوث انقلاب 1989، تلك مشاكل واجهتها حكومة منتخبة لم تتمكن من الصمود أمام المصاعب الأمنية والاقتصادية والضغوط النقابية الداخلية وضغوط المجتمع الدولي، فهل تستطيع حكومة انتقالية تستند إلى مجرد وثيقة مختلف حولها تبنتها لجنة تيسيريه لنقابة إدارة الدولة حتى إذا ما كانت تلك الحكومة مدنية ومستقلة ، وهل هناك ضمانات من المجتمع الدولي إذا ما تم تمرير الاتفاق وفقاً لرغبته أن تأتي المساعدات للحكومة المستقلة ، لقد قدمت بريطانيا بعد تمرير اتفاقية الميرغني قرنق في الجمعية التأسيسية ( بتوضيحاتها) 5 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات إنسانية ، وجاءت بعثة من صندوق النقد للتباحث وفرض شروط جديدة وظلت كلها وعود معلقة في الهواء ، لا أتصور أن المجتمع الدولي أو الإقليمي سوف يتجاوب مع حكومة غير منتخبة بالكرم الذي تتوقعه بعض القوى السياسية( تاماً كما حدث بعد اتفاقية ( نيفاشا) التي هندسها المجتمع الدولي وتقاعس عن دعمها، لذلك لن تنجح حكومة سوف يتم التوافق عليها لا يكون لها سند بخلاف أن يكون لها أكبر اجماع داخلي تستند عليها حتى وصول البلاد إلى الانتخابات .
في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية يجب على اتفاق المرحلة الانتقالية أن يراعي قدرة الحكومة الانتقالية على تحمل تبعات القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها طبعاً بجانب معيشة الناس ,لكن الأمن من مقومات الحياة ولن يعيش الانسان بدون أمن وينتظر الحكومة تنفيذ الترتيبات الأمنية مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ، والأوضاع الأمنية غير المستقرة مع بعض دول الجوار ، والمهددات القبلية الداخلية ،والمطالب النقابية ، فهل تستطيع حكومة مدنية بالكامل كما يقال أن تمسك بزمام الأمور وتسيطر على الأوضاع دون مشاركة القوات المسلحة في السلطة ، وهو أمر فشلت فيه قيادات سياسية تاريخية حتى بعد انتخابات 1986 ، الأمر اقرب إلى الحلم والقفز في الهواء إلى المجهول.
بعد خطاب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ومساندته للسيد جعفر الصادق، يبدو أن الخلاف قد عاد بنا إلى المربع الأول الذي حدث بين الحزبين مع اتفاقية الميرغني قرنق، وعاد صراعاً بين الحزبين الكبيرين ، ومن غرائب السياسة في السودان أن خطاب مولانا يضع الحزب في تقارب واضح مع كل من الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي من مسودة المحامين ، وحزب البعث له تاريخ تحالف مع الاتحاديين أيام صدام حسين ومساندة القوات المسلحة ببعض العون العسكري العراقي خلال معارك الكرمك عندما خرج الناس يرددون( عاش أبو هاشم) ، وما اشبه الليلة بالأمس في نفس المنطقة ، ولكن صدام حسين ليس موجوداً الان ، ولكن مولانا الميرغني يملك الان اوراقاً أقوى من صدام حسين ، وهو مثل والده الذي كان يوصف بالذكاء عندما ظل يتحدث الصحفي محمد حسنين هيكل عند مقابلته له قبل الاستقلال عن سورة النمل ولم تخرج منه بكلمة مفيدة عن العلاقة مع مصر حتى لا يقع في الحرج وهو يعلم أن السودان كان متجهاً إلى الاستقلال ، مولانا الميرغني الزعيم خليفة والده في خطابه تحدث عن جون قرنق ولكنه لم يذكر ( بتوضيحاتها ) ، ومن المؤكد أنه سدد ضربة موجعة ، وربما تمر وثيقة المحامين ولكن (بتوضيحاتها ) بعد جراحة ومباركة من مولانا.