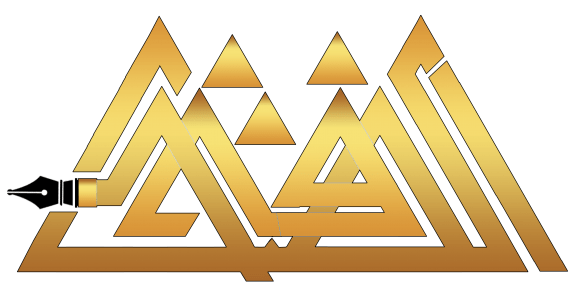جريدة بريطانية الأحزاب السودانية ..غير قادرة على إدارة الاختلاف السياسي بسوية وطنية
جريدة بريطانية الأحزاب السودانية ..غير قادرة على إدارة الاختلاف السياسي بسوية وطنية
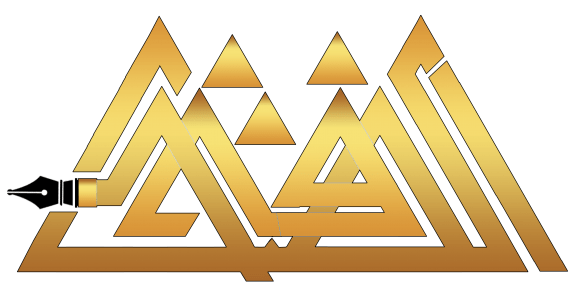
كتب :محمد جميل أحمد
منذ أن استقل السودان، اتفق لنخبه المتعلمة استلهام حياة مغتربة كان مثالها الإنجليز الذين استعمروا البلاد. فكان قياس استلهام القدوة، مع الفارق الذي يتوخاه خريجو كلية غردون (جامعة الخرطوم في ما بعد) تلك النخبة الإنجليزية، الأمر الذي بدا معه لوهلة أولى أن ذلك الاستلهام يمنح صاحبه مكانة في المجتمع. لقد كان خريجو السودان الذين انتظم مؤتمرهم تأسيساً عام 1938 يقاربون الشأن السياسي بطريقة غريبة، فمن ناحية كان في استلهام اسم مؤتمر الخريجين بسبب من التأثر بحزب المؤتمر الذي أسسه غاندي في الهند يوحي بأنهم مدركون لمعنى فلسفة غاندي في التعامل المزدوج مع الاستعمار، أي في كون الظاهرة الاستعمارية ظاهرة قابلة للتعلم والمقاومة، لكن الحقيقة المؤسفة، من ناحية ثانية، أكدت أن ذلك الاستلهام الشكلاني للطبقة الإنجليزية في أوساط أولئك الخريجين هو واقع حياة أولئك الخريجين في استبطانهم للمثال الإنجليزي المضلل.
وكان في هذا الاحتذاء لأول عهده زخم عاش بسببه أولئك الخريجون السودانيون حياة رغيدة ومؤقتة ومنفصلة في الوقت ذاته عن حال السودانيين الآخرين من عامة الشعب، لكن مع مرور السنوات وظهور فوارق غياب الإنجليز في إدارة البلاد بدأ يطل برأسه على شكل تنبيهات حرجة ومواقف دالة كانت تتزايد مع تراخي قبضة أولئك الخريجين في مقاييس الجودة حيال إدارة بنيات الدولة المدنية التي ورثوها عن الاستعمار، كالتعليم والخدمة المدنية، من دون أن تلقى تلك التنبيهات ما يليق بها من درس وحذر في عقول الطبقة والنخبة المتعلمة، فبدت الأمور تنحو ببطء إلى تداعيات غير مرئية، لكنها ظلت تتراكم باستمرار.
ومن أكبر التنبيهات التي واجهت تلك النخبة السودانية المغتربة كتاب المفكر السوداني الليبرالي الكبير الراحل منصور خالد بعنوان “النخبة السودانية وإدمان الفشل”. في مثل هذه الأجواء، نشأت الأحزاب السودانية من دون أن يكون لها قائد رائي وملهم مثل غاندي في الهند، فيما كان يخضع الحزبان الكبيران في البلاد (حزب الأمة – والحزب الاتحادي الديمقراطي) لزعيمين كبيرين (عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار، وعلي الميرغني زعيم طائفة الختمية)، لكن المفارقة كانت تتمثل في أن هذين الزعيمين روحيان، كما كانا زعيمان لطائفتين دينيتين، الأمر الذي كرس من البداية شللاً إرادياً في طبيعة تأثير هذين الزعيمين وما يتصل بتعاملهما في تدبير الرعاية الحزبية من دون الخوض المباشر في مجريات السياسة. لقد كان ثمة انفصال واضح بين مستويين في بنية الحزبين الكبيرين، ففي الوقت الذي كان سياسيو الحزبين الكبيرين يخضعان في النهاية لاختيارات مرجعية الزعيمين، كان الأخيران في الوقت ذاته يظهران حرجاً وتعالياً عن الخوض في مجريات سياسية ظاهرة، في وضع غريب بالفعل وسم الحياة السياسية للسودانيين منذ نهاية الأربعينيات وحتى بداية الستينيات من القرن العشرين. وبما أن السياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ، كانت هذه الحالة الغريبة للحزبين الطائفيين الكبيرين، سرعان ما أظهرت في أفق التنافس معهما أحزاباً عقائدية حديثة تزامنت مع أحوال ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي مناخ الحرب الباردة، فكان الصراع بين المعسكرين (الرأسمالي بقيادة أميركا، والاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وكان على رأس تلك الأحزاب التي تغولت في قواعد الحزبين الطائفيين، حزبان عقائديان جديدان، هما الإخوان المسلمون والشيوعيون). ما كان غائباً في أطوار المرحلة الحزبية منذ انقسام مؤتمر الخريجين في الأربعينيات وتحول منسوبيه إلى الحزبين الطائفيين الكبيرين، مع بقاء نسبة صغيرة لا تذكر خارجهما، هو تلك “السرنمة” المتصلة بتقليد طبقة الإنجليز التي شغلت طبقة الخريجين الحزبيين عن التفكير في معنى وهوية وفلسفة الحزب، أي في المبدأ التفسيري المتصل بفكرة الحزب من حيث كونه حزباً.
يضاف إلى ذلك أن أولئك الخريجين كانوا غالبية من منطقة واحدة (الشمال والوسط) فبدا لكثيرين منهم أن واقع الحال (حين لم تكُن هوامش السودان وأطرافه في وارد تفكيرهم) هو الذي أرادوه في خيالهم كأفندية وورثة للإنجليز، على الرغم من المنبهات الأولى التي ذكرنا من قبل (وكان قيام مؤتمر البجا في شرق السودان عام 1958 أحد تلك المنبهات)، وكذلك من قبله أحداث مدينة توريت العسكرية في جنوب السودان عام 1955. وكذلك كان مناخ الاستقطاب بين اليمين واليسار والأيديولوجيا الحدية المتمانعة شاغلاً آخر لمنسوبي الأحزاب العقائدية في السودان عن ملفات وطنية كثيرة، كالتفكير في معنى الهوية الوطنية التي لم تكُن ناجزة في ذلك الوقت، لكن الخيال السياسي لتلك النخبة الحزبية في الوسط والشمال كان قد حسم الهوية السودانية بوصفها هوية عربية. كما جاء في بعض أبيات شاعر مؤتمر الخريجين خضر حمد حين صاغ نشيد مؤتمر الخريجين الذي جاء في بعض أبياته: “أمة مجدها للعرب * دينها خير دين يحب”. لقد كان داء المركزية المنحصر في الوسط والشمال مع حيوات فائض مواطني ذلك الوسط في بقية أقاليم السودان هو الذي منع، إلى جانب فكرة الهوية العربية، من الاكتراث لبقية الشعوب السودانية وما تختزنه تلك الشعوب من حرمان في أرضها لمجرد أن لسانها لم يكُن عربي الأصل، وهم غالبية أهل السودان في جهاته الأربع. وهكذا ظل السودان غارقاً في تلك المركزية المناطقية الضيقة من دون أن تعي نخبه في المركز هوية الأفكار التي تليق بإدارة بلد كبير ومتعدد في الأعراق واللقاء مثل السودان، ما أدى بعد ذلك إلى انفجار القنابل الزمنية الموقوتة، التي تم إهمال معالجاتها المستحقة في أزمنة سابقة، فصار التعبير عن الأزمات والصراع هو الجانب الأبرز منها.
وعلى ضوء ما أسلفنا، تبدو الأحزاب المركزية السودانية، على ما فيها من ضعف اليوم، كما لو أنها لم تنسَ ولم تتعلم حيال اكتراثها لاستصحاب فهم مشكلات الأطراف والهوامش، في الوقت الذي تحولت تلك الأطراف والهوامش إلى ظواهر سياسية عبرت عن نفسها بهويات سياسية مناطقية تحول بعضها لاحقاً إلى حركات مسلحة ضد الدولة المركزية في الخرطوم، الأمر الذي زاد الطين بلة. وأخيراً، بانقلاب الإخوان المسلمين على يد البشير– الترابي عام 1989 تم تدمير قواعد اللعبة السياسية حين أحيا الإخوان المسلمون نظام الإدارة الأهلية وعملوا على تسييس القبائل لتكون بديلة عن الأحزاب، الأمر الذي أدى إلى تخريب النسيج الاجتماعي، بحيث صار التعبير عن قضايا المجال العام ينطوي على منظور قبائلي ضيق يتم الاحتكام حول الخلاف عليه إلى السيف من خلال الحساسيات والنعرات. والأخطر من ذلك ما ظلت تعانيه الأحزاب السودانية ذاتها من لبس مدني حداثي خادع، كشف عن زيفها وما تنطوي عليه في الحقيقة من تعبير عن بنيات تقليدية قبائلية ومناطقية، عكست هويتها الحقيقية في كونها أحزاباً تمارس عجزاً فاضحاً حيال هويتها ومعناها، أي في كونها تنطوي على عجز أساس بدا اليوم ظاهراً في عدم القدرة على إدارة الاختلاف السياسي بسوية وطنية، وعدم القدرة على تقديم نموذج وطني ناجح في إدارة المرحلة الانتقالية السابقة، بل وعدم القدرة على التوافق على سقف وطني متميز عن سقوفها الحزبية الضيقة التي تساوي بين مصلحتها الفئوية ومصلحة الوطن. كما هي عاجزة اليوم في ظل هذا الخطر الوجودي المحقق بالسودان، عن تكوين جبهة جمهورية موحدة لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. إن أهم ما ينطوي عليه فشل الأحزاب السودانية اليوم أنه يثير أسئلة حقيقية ويعيد التساؤل عن بديهيات سياسية قد تنطوي الإجابة عنها عن حقيقة صادمة، أي أسئلة من قبيل: هل هذه الأحزاب اليوم تعبر عن شعب أم عن هويات ما قبل حديثة، كالقبيلة والطائفة والمنطقة؟ وهل مفهوم الشعب كحقيقة سياسية يعتبر مفهوماً ناجزاً في تعبيره عن السودانيين أم أن الحقيقة في مكان آخر؟ هذه كلها أسئلة تكشفت اليوم في ظل هذه الأزمة المصيرية للسودان كما لم تتكشف من قبل.
الوضع في السودان، لا تزال تعبيرات الأحزاب السياسية عن نفسها قاصرة بامتياز عن التعالي إلى مستوى التعبير عن هوية الوطن الدال عن الهوية السياسية للشعب. إن إشكالية الأحزاب السودانية اليوم تعيدنا باستمرار إلى التفكير في الأسئلة الأساسية لاجتماعنا السياسي كسودانيين، وهي أسئلة لا تزال الإجابات عنها في تقديرنا إجابات ناقصة وغير حقيقية