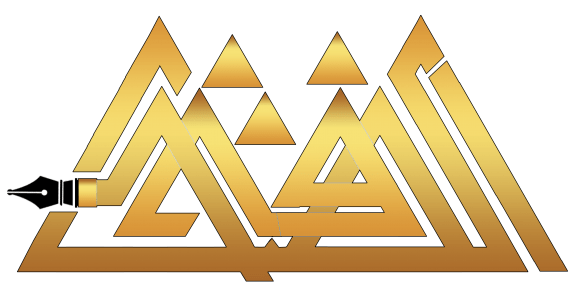العملية السياسية الحالية الى أين تمضي بالسودان؟ أمجد فريد الطيب

لعل ما يحدث الآن من تعثر في مسار العملية السياسية، هو عرض على المرض الأكبر الذي أصاب الفترة الانتقالية منذ بدايتها في ٢٠١٩ وادي الى تعثرها حتى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩، وهو السعي الى تسييس عمليات الإصلاح في أجهزة الدولة والاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية للأطراف المختلفة الى أقصى حد ممكن.
عرقل هذا الاستقطاب مهمة إصلاح القطاع الأمني والعسكري، منذ البداية، حيث قاومت المكونات العسكرية، سواء كانت في الجيش أو الدعم السريع، هذه العملية منذ بدء الفترة الانتقالية، وعرقلت أي إجراءات عملية للمضي فيها قدماً، وانحصر الخطاب والعمل السياسي الرسمي حول إصلاح القطاع الأمني في الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق سلام جوبا، وكان عدم بدء وتقدم هذه العملية هو أحد الأسباب الأساسية التي مهدت وأدت الى انقلاب ٢٥ أكتوبر.
العملية السياسية الحالية، منذ أن بدأتها قوى الحرية والتغيير مع قيادة الانقلاب سراً، ثم خرجت – أو أُخرجت – الى العلن، تحول هدفها بشكل مضطرد من إنهاء الانقلاب وإعادة الانتقال المدني الديمقراطي في السودان الى مساره المرتبط بأهداف الثورة والتغيير وما يتعلق بها من عمليات إصلاح ضرورية ذات طابع جذري وتأسيسي في جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري، الى محض محاولات حثيثة – ورخيصة للأمانة – للعودة الى السلطة بدون تمحيص فيما يحدث بعد ذلك، وتم استخدام كل أدوات التضليل والبروباغاندا في الترويج لهذه العودة باعتبارها انتصاراً لإرادة شعبية، بينما الإرادة الشعبية لا تزال – رغم إرهاقها المتزايد من الوضع الحالي – تنظر بكثير من الشك الى مخرجات هذه العملية المتعثرة في أن تقلب تحالفات الانقلابيين مع القوى السياسية، وتحولها من ضفة الكتلة الديمقراطية الى الانخراط مع المجلس المركزي، الى جعل هذه العملية جزئية بشكل يهدد قدرة مخرجاتها على تحقيق أي استقرار ناهيك عن استعادة مسار الانتقال.
أدى تحول العملية السياسية الى مجرد ساحة الى حصد المغانم السلطوية، الى تحويل نقاش القضايا الى مساومات خذ وهات لا يتم التركيز فيها بشكل كبير على الأهداف المتعلقة بالانتقال ذات نفسه، وكما أدى الى استشراء داء تسييس قضايا الإصلاح ومهام الفترة الانتقالية المختلفة بما جعلها فرصة ليحصد كل طرف من الأطراف السياسية ما يستطيع من مكاسب، ولأن دافع القوى المدنية المشاركة (قوى المجلس المركزي ومن استصحبته معها من حلفاء النظام البائد) أصبح مجرد الرجوع الى السلطة فقد كانت الأكثر كرماً في منح التنازلات.
ماذا يريد العسكر؟ حصانة من المحاسبات، فمنحوهم الحصانة في عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وحاولوا إخراجها عبر نقاشات فوقية لقضية العدالة الانتقالية بمناقشة تجارب كولومبيا، وجنوب أفريقيا، ولكن أغفلت مناقشة المسئولية السياسية عن الجرائم التي تم ارتكابها، بما حول مخرجاتها الى محض تقنين كامل للإفلات من العقاب، وتم تحلية الصفقة بالمشاركة في تبييض اسم وسمعة قوات الدعم السريع وقائده حميدتي والتي لم تبدأ بتسميته شخصية العام للحقوق الإنسان في السودان واستمرت في إعادة تقديمه كحليف للقوى الديمقراطية في أحد مغريات التحالف المتنامي بينهما.
ورشة معالجة إشكالات اتفاق جوبا، تم عقدها بدون مشاركة أغلب الموقعين، ودون مناقشة حقيقية لما هي هذه الإشكالات على أرض الواقع، ولم تخرج سوى بتكرار الورشة مرة أخرى في جوبا وبدون توصيات ذات معنى تعالج الأزمة الحقيقية في فترة الانتقال، وهو تعريفها كفترة لإنجاز مهام الإصلاح وإعادة البناء وليس التصارع على الحكم والسيطرة.
مضت ورش الاتفاق الإطاري في ذات المنهج التسابق للانتهاء منها بأي شكل كان، انصرافاً للتركيز على الجائزة والهدف الرئيس من العملية وهو غنيمة السلطة، ولكن الأمر انفجر في ورشة الإصلاح الأمني الأخيرة، والتي يتربع الفاعلين الأساسين (الجيش وقوات الدعم السري) في مناقشتها على سدة السلطة بالفعل، ولذلك سعى الطرفان الى التركيز على حصد مكاسب سياسية أخرى طويلة الأمد لكل منهما على حساب الآخر، بغض النظر عن منطقية السعي لهذا الحصاد من عدمه، لكن الخطورة الأكبر في هذه العملية أنها عملية مفصلية تتعلق بالتاريخ السياسي السوداني واستخدام السلاح فيه، بما جعل صراع السياسة في السودان مرتبطاً بالسطوة والنفوذ العسكري القادر على الانقلاب على أي أسس متفق عليها الديمقراطية، وجعل السودان يتصدر قائمة الدول الأفريقية التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات ومحاولات الانقلابات العسكرية، عملية الإصلاح العسكري والأمني لا تصلح لأن تكون مرتعاً للمزايدات السياسية، ومفاهيم مثل خضوع الأجهزة العسكرية للرقابة المدنية، ووحدة هياكل السيطرة والتحكم وقيادة القوات المسلحة في البلاد، وأساليب ومناهج التجنيد والتدريب والتسليح، ليست مرتبطة – ولا ينبغي لها – بالسعي لوجود حليف يملك السلاح والنفوذ العسكري للانحياز لفرض هذه الأجندة أو تلك، هذا خطأ منهجي تقع فيه قوى الحرية والتغيير – ومن يمشي معها في ركبها – حين تحاول بناء هيكل ديمقراطي باستخدام أدوات قمعية، الدعم السريع تم إنشاؤه خلال عهد البشير كأحد أدوات القمع والحرب الأهلية، وهذا أساس متجذر لا يصلح لتحويلها بين ليلة وضحاها الى أداة لبناء الديمقراطية وتمدين الحياة السياسية، ذلك ناهيك عن أن حميدتي وقواته لم توفر جهداً في الانخراط في قضايا وشؤون إقليمية ودولية، تكشف بوضوح عن طموحات قائدها في استخدام هذه القوات كرافعة لطموحاته السياسية داخل وخارج السودان.
وعلى صعيد آخر، فإن الجيش السوداني مصاب بداء العمل السياسي. ولعبت فترات الحكم العسكري المطولة في البلاد وآخرها في عهد التحالف سيئ السمعة بين الجبهة القومية الإسلامية والعسكرتاريا الذي استمر في حكم البلاد على مدى ٣٠ سنة، في تحويل عقيدة قوات المسلحة في فهمها لعلاقتها مع جهاز الدولة من دور (الحماية) الى دور (الوصاية) بحيث أصبحت تعتبر نفسها كياناً فوق جهاز الدولة وليست جزءاً منه، تمتد شواهد ذلك من تصريحات الجنرال البرهان وحتى الشعور الطاغي لدى “الخبراء الاستراتيجيين” الذي يعتبرون أن أي هراء يقولونه هو من جوامع الكلم التي ينبغي أن يقتنع بها الجميع.
ولكن عملية إصلاح هذه المؤسسة لا ينبغي التعامل معها كعملية انتقام أو إذلال، بل هي عملية إصلاح لا تختلف في طبيعة أهدافها عن إصلاح النظام الصحي في البلاد أو إصلاح وزارة المالية أو الإصلاح الاقتصادي، الغرض من هذه العملية هو استعادة الدور الطبيعي الذي ينبغي أن يلعبه السلاح المملوك للدولة ضمن السياق الطبيعي لأدوار جهاز الدولة، واستعادة المؤسسات العسكرية والأمنية لوضعها الطبيعي كأحد الأجهزة الخدمية ذات الطبيعة المهنية الخاصة، بل إن خضوعها للإدارة والإشراف المدني وتنفيذ السياسات التي تقررها قيادة الجهاز التنفيذي لا يختلف عن خضوع بقية أجهزة الدولة كوزارة الصحة أو الرعاية الاجتماعية أو التعليم وليس خصماً عليها، بل إن ما يخصم منها في الحقيقة هو الوضع غير الطبيعي الذي يصنعه استقلالها ومشاركتها السياسية.
منذ وقت مبكر في العملية السياسية، أدرك الوسطاء الدوليون، التحول الذي حدث في طبيعة وأهداف العملية السياسية وتحولها إلى سباق مغانم يهدف إلى السلطة، ولذلك أصبحت وساطتهم تتركز حول هذه النقطة، ولعل زلة اللسان أو الإشارة المقصودة، التي وردت في تقرير الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس الأخير لمجلس الأمن، عن أن جبريل ومناوي يسعيان فقط لضمان مشاركتهما في السلطة القادمة، تصلح للتعميم على جميع المشاركين في العملية الحالية، حيث أن فولكر يعرف تماماً أن هذه العملية التي أصبح يلعب فيها بمعية آخرين دور المخرج لما ينتجه كتاب السيناريوهات في المجلس المركزي ويأتيه جاهزاً لبحث كيفية تنفيذه، أصبح الغرض منها الوصول الى معادلة لتقسيم السلطة وضمان النفوذ وليس دعم التحول الديمقراطي بشكل حقيقي، ولهذا أصبح الوسطاء الدوليزن وموظفوهم في – أمم متحدة وسفراء واتحاد أفريقي وإيقاد وغيرهم – يرددون بثقة بعض الدفوعات الغريبة وكأنها ثوابت منطقية، مثل عدم قبول برهان كقائد للجيش بخضوع الجيش لإدارة مدنية غير منتخبة، وهو في ذلك يشكك في شرعية هذه الإدارة في المقام الأول، فلماذا يشارك فيها.. وما هو هذا الوضع الغريب الذي لا يتمتع فيه جيش الدولة باستقلال عن الجهاز التنفيذي للدولة، شرعية الانتقال وحكومته هي من شرعية الثورة، ومن لا يقبل بهذه الشرعية، فالأولى به أن لا يشارك فيها، وثانية الغرائب أن حميدتي لا يعترض على أن يكون جزءاً من الجيش ولكنه لا يرغب في أن يخضع أو يكون تابعاً للقائد العام للجيش وأنه يفضل التبعية لرأس الدولة – ذو المهام الشرفية- ناهيك عن أن ذلك يجعل القائد العام ليس قائداً ولا عاماً، لم يخبرنا أي من هؤلاء الخبراء الأممين عن كيف يستقيم هذا الوضع مع السعي لإنهاء تعدد الجيوش وحاملي السلاح في الدولة، وكل هذه الغرائب التي يتم التعامل معها كأسانيد منطقية في بلاد العجائب السودان، مرتبطة بيقين هؤلاء الوسطاء الدوليين أن الأمر لا يعدو مجرد مساومة على مائدة السلطة وليس السعي لاستعادة مسار الانتقال بشكل حقيقي، وفي هذا أيضاً يدخل النقاش حول فترة دمج الدعم السريع، التي يتحدث البعض عن حوجتها لعشرة أعوام، وبينما يدفع آخرون بحاجتها لعامين فقط لتصبح الوساطة في إقناعهم بالقبول بحل وسط في خمسة أعوام! دون أن يجيب أحد هؤلاء الجهابزة على سؤال الى ماذا تستند هذه الأرقام، فالدعم السريع لا تختلف عن الجيش في شيء سوى تركيبها القبلي وهو الأمر الذي ينبغي أن ينتهي في أي عملية إصلاح، ولكنها قوات كانت تحارب نفس العدو، وبذات العقيدة القتالية ونفس الأسلحة والتدريب، بل إن عدداً مقدراً وكبيراً من ضباطها هم من الضباط السابقين في القوات المسلحة، فلماذا يحتاج دمجها الى عشرات السنين؟! إذا لم يكن الأمر مجرد مساومة حول استمرار النفوذ السياسي لقائدها!
أصبح المجتمع الدولي ووسطاؤه يسعون إلى مجرد الوصول الى اتفاق.. أي اتفاق وبأي شكل كان، وأصبح تركيز بعض إذا لم يكن غالبية الموظفين الأممين والمبعوثين الدوليين هو في الاحتفال بانتهاء ناجح للعملية السياسية، بغض النظر عما ستنتجه مخرجاتها وإذا ما كانت تخدم أهداف الثورة وتسهم في تحقيق الاستقرار والديمقراطية في السودان أم لا. فهذا لن يعنيهم في شيء فهي مجرد نقطة أو إنجاز يضاف إلى سيرهم الذاتية. وهم يعلمون كما نعلم أيضاً أن نصوص الاتفاقات في السودان لا تعني شيئاً كثيراً، وأن الحكم الأساسي في مسار الأحداث سيتعلق بتوازن القوى في تشكيل الحكومة التي تليه. ولكن الشاهد أن استشراء حالة المساومة السياسية الحالية سيقود البلاد في طريق تكوين حكومة متعددة الرؤوس، وما قتل ميدوسا في الميثولوجيا الإغريقية إلا تعدد رؤوسها.
إن الحديث عن تأجيل المعارك، والتعامل مع الواقع ربما يكون فيه بعض الحكمة ولكن هذا التأجيل لا ينبغي أن يعني التناسي ولا التجاهل، وهذا كان الخطأ الذي وقعت فيه قوى التحول الديمقراطي في ٢٠١٩. من الضروري الاستمرار في الإشارة الى المعضلات والتعقيدات التي تصنعها الاتفاقات الحالية والاستعداد لمواجهتها.
إن السودانيين يصنعون المستقبل الآن بخياراتهم والطريق يصنعه المشي.. فإما أن نختار من الأمور أصلحها من أجل بناء مستقبل أفضل نصنعه هنا والآن، وإما أن نكتب على أنفسنا الدوران في دوائر مغلقة لا تمضي بنا إلا مكانك سرك.
http://sudanseen.blogspot.com/2023/04/sudanpoliticalprocess.html